أبيرامينثو (يسوع)
هو الشخصية المحورية في المسيحية وزعيم الكنيسة الغنوصية.
يُطلق عليه الناس المعاصرون اسم يسوع المسيح، لكن هذا ليس اسمه عند الولادة، بل هو لقب مكتسب.
اسم “يسوع” مشتق من الكلمة الآرامية (العبرية القديمة) יהשוה يشوع، والتي تعني “المخلص”، وهو مشتق من اسم الله القدوس יהוה المملوء نارًا ش. وقد استُخدم هذا المصطلح في الأصل كلقب تشريفي، مثل “حاخام”.
كلمة المسيح مشتقة من الكلمة اليونانية Χριστός ، Christos، أي “الممسوح”، وكلمة Krestos، و التي تعني في اللغة الباطنية “النار”.
وكلمة المسيح أيضًا لقب، وليس اسمًا شخصيًا.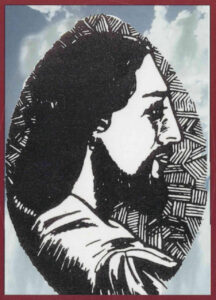
في كتاب “بيستيس صوفيا”، ورد اسمه باللغة القبطية باسم أبيرامينثو.
“قال يسوع، أي أبيرامينثو،…” – بيستيس صوفيا
أبيرامينثو اي المسيح …
لا يعرف الجمهور إلا القليل عن تفاصيل حياته الحقيقية، باستثناء ظهوره على الأرض قبل نحو ألفي عام، وإشعاله شعلة روحية قلّما يدركها احد أو يجسّدها.
تُعرف تعاليمه بشكل خاص في أناجيل العهد الجديد من الكتاب المقدس، ولكنها حاضرة أيضًا في كتاب “صوفيا” (Pistis Sophia) وفي مجموعة متنوعة من النصوص الأخرى.
دراسة حياة وتعليمات أبيرامينثو (يسوع)
الألغاز الكبري تُكشف عن القصة الحقيقية لحياة يسوع الناصري للعالم …
لا في الأناجيل المقبولة ولا في الأسفار القانونية غير الرسمية، مع أنه يمكن العثور على بعض التلميحات الطريفة في بعض الشروح التي كتبها آباء ما قبل مجمع نيقية.
وتُعدّ الحقائق المتعلقة بهويته ورسالته من بين الأسرار الثمينة المحفوظة حتى يومنا هذا في الأقبية السرية أسفل “بيوت الإخوة”..
وقد روى جزء من هذه القصة الغريبة لبعض فرسان الهيكل، الذين تلقّوا تعليمهم في أسرار الدروز والناصريين والإسينيين واليوحناويين، وغيرهم من الطوائف التي لا تزال تسكن معاقل الأرض المقدسة النائية والمنعزلة.
ولا شك أن معرفة فرسان الهيكل بالتاريخ المبكر للمسيحية كانت أحد الأسباب الرئيسية لاضطهادهم وفنائهم النهائي.
إن التناقضات في كتابات آباء الكنيسة الأوائل ليست متناقضة فحسب، بل تُثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه حتى خلال القرون الخمسة الأولى بعد المسيح، لم يكن لهؤلاء العلماء أساسٌ لكتاباتهم سوى التراث الشعبي والإشاعات.
بالنسبة للمؤمن البسيط، كل شيء ممكن، ولا توجد أي مشكلة. أما الباحث عن الحقائق دون عاطفة، فيواجه مجموعة من المشاكل ذات العوامل غير المؤكدة، ومن أبرزها ما يلي:
بحسب الاعتقاد السائد، صُلب يسوع في السنة الثالثة والثلاثين من حياته وفي السنة الثالثة من خدمته بعد معموديته. حوالي عام ١٨٠ ميلادي، كتب القديس إيريناوس، أسقف ليون، أحد أبرز علماء اللاهوت قبل مجمع نيقية، كتاب “ضد الهرطقات”، هجومًا على عقائد الغنوصيين.
في هذا العمل، أعلن إيريناوس، مستندًا إلى أقوال الرسل أنفسهم، أن يسوع عاش حتى بلغ سن الشيخوخة.
مجرد اقتباس: “لكنهم، لكي يثبتوا رأيهم الخاطئ فيما هو مكتوب: “لإعلان سنة الرب المقبولة”، يزعمون أنه بشر سنة واحدة فقط، ثم عانى في الشهر الثاني عشر. [بقولهم هذا]، ينسون عيبهم، ويدمرون عمله كله، ويسلبونه ذلك العمر الذي هو أحق وأشرف من أي عمر آخر؛ أعني ذلك العمر المتقدم، الذي تفوق فيه كمعلم على الجميع.
التعاليم
فكيف كان له تلاميذ إن لم يكن قد علّم؟
وكيف كان له أن يُعلّم إن لم يكن قد بلغ سن المعلم؟
لأنه عندما جاء ليعتمد، لم يكن قد أكمل الثلاثين من عمره، بل كان قد بدأ في الثلاثين من عمره تقريبًا (لأن لوقا، الذي ذكر سنواته، عبّر عن ذلك بقوله:
“وكان يسوع، كما لو كان قد بدأ الثلاثين من عمره”، عندما جاء ليعتمد)؛ و(حسب هؤلاء الرجال) لم يكرز إلا سنة واحدة من معموديته.
وعندما أكمل الثلاثين من عمره، عانى، وهو في الواقع شاب، ولم يبلغ سن الرشد.
والآن، فإن المرحلة الأولى من الحياة المبكرة تشمل ثلاثين عامًا، وأن هذا يمتد إلى الأربعين، وهذا ما سيعترف به الجميع؛ ولكن من الأربعين إلى الخمسين يبدأ الإنسان في الانحدار نحو الشيخوخة، التي امتلكها ربنا وهو لا يزال يؤدي وظيفة المعلم، كما يشهد الإنجيل وجميع الشيوخ؛ أولئك الذين كانوا على دراية بيوحنا، تلميذ الرب، (مؤكدين) أن يوحنا نقل إليهم هذه المعلومات.
وبقي بينهم حتى زمن تراجان.
علاوة على ذلك، رأى بعضهم ليس يوحنا فقط، بل الرسل الآخرين أيضًا، وسمعوا نفس الرواية منهم، ويشهدون على صحة العبارة.
فمن يجب أن نصدق إذن؟ “فهل هؤلاء الرجال أم بطليموس الذي لم ير الرسل قط، ولم يتوصل حتى في أحلامه إلى أدنى أثر لرسول؟”
في تعليقه على المقطع السابق، يُشير غودفري هيغينز إلى أنه لحسن الحظ أفلت من أيدي أولئك المُدمرين الذين حاولوا جعل روايات الأناجيل متسقة بحذف جميع هذه العبارات.
كما يُشير إلى أن عقيدة الصلب كانت محل جدل بين المسيحيين حتى خلال القرن الثاني.
ويقول: “لا يُمكن المساس بشهادة إيريناوس. فهي، وفقًا لجميع مبادئ النقد السليم، وعقيدة الاحتمالات، لا تُشكك فيها”.
تجدر الإشارة أيضًا إلى أن إيريناوس أعد هذا البيان ليناقض بيانًا آخر، يبدو أنه كان شائعًا في عصره، مفاده أن خدمة يسوع لم تدم سوى عام واحد.
من بين جميع الآباء الأوائل، كان من المفترض أن يمتلك إيريناوس، الذي كتب بعد ثمانين عامًا من وفاة القديس يوحنا الإنجيلي، معلومات دقيقة إلى حد معقول.
إذا كان التلاميذ أنفسهم قد رووا أن يسوع عاش حتى سن متقدمة في الجسد، فلماذا اختير الرقم 33 الغامض عشوائيًا ليرمز إلى مدة حياته؟
هل تم تغيير أحداث حياة يسوع عمدًا لتتناسب أفعاله بشكل أوثق مع النمط الذي وضعه العديد من الآلهة المخلصين الذين سبقوه؟
يتضح من قراءة كتابات جوستين (جاستين) الشهيد، وهو مرجع آخر من القرن الثاني، أن هذه التشبيهات قد استُخدمت كوسيلة ضغط في تحويل اليونانيين والرومان.
في كتابه “الاعتذار”، يخاطب جوستين الوثنيين على النحو التالي:
وعندما نقول أيضًا إن الكلمة، وهو الميلاد الأول لله، وُلد بدون اتحاد جنسي، وأنه، يسوع المسيح، معلمنا، صُلب ومات وقام وصعد إلى السماء، فإننا لا نطرح شيئًا مختلفًا عما تعتقدونه بشأن أولئك الذين تعتبرونهم أبناء جوبيتر (زيوس) * * *
وإذا كنا نؤكد أن كلمة الله وُلد من الله بطريقة غريبة، مختلفة عن الولادة العادية، فليكن هذا، كما ذكرنا آنفًا، أمرًا غير عادي بالنسبة لكم، أنتم الذين تقولون إن ميركوري ( هرمس) هو كلمة الله الملائكية.
ولكن إذا اعترض أحد على أنه صُلب، فهو في هذا أيضًا على قدم المساواة مع أولئك الذين يُزعم أنهم أبناء جوبيتر (زيوس) لديكم، والذين عانوا كما ذكرنا الآن.
ومن هذا يتضح أن المبشرين الأوائل للكنيسة المسيحية كانوا أكثر استعدادًا للاعتراف بالتشابه بين إيمانهم وإيمان الوثنيين من خلفائهم في القرون اللاحقة.
في محاولةٍ لحل بعض الإشكاليات التي تعترض أي محاولة لتوثيق حياة يسوع بدقة، أُشير إلى أنه ربما عاش في سوريا آنذاك اثنان أو أكثر من المعلمين الدينيين الذين يحملون اسم يسوع، أو يشوع، أو يوشع، وأن قصص هؤلاء الرجال ربما اختلطت في قصص الأناجيل.
في كتابه “الطوائف السرية في سوريا ولبنان”، يقتبس برنارد هـ. سبرينغيت، وهو مؤلف ماسوني، من كتابٍ قديم، لم يكن من حقه الكشف عن اسمه لارتباطه بطقوس إحدى الطوائف. والجزء الأخير من اقتباسه وثيق الصلة بالموضوع المطروح:
لكن يهوفا أنعش نسل الإسينيين، في القداسة والمحبة، لأجيال عديدة. ثم جاء رئيس الملائكة، بأمر الله، ليُقيم وريثًا لصوت يهوفا.
وبعد أربعة أجيال أخرى، وُلد وريث، واسمه يشوع، وهو ابن يوسف ومارا (مريم ، ماري) ، عبد يهوفا المتدينين، اللذين انعزلا عن جميع الناس باستثناء الإسينيين.
وهذا يشوع، في الناصرة، أعاد يهوفا إلى مكانته، وأعاد العديد من الطقوس والشعائر المفقودة. وفي السنة السادسة والثلاثين من عمره، رُجم حتى الموت في أورشليم
خلال القرن الماضي، نُشرت عدة كتب تُكمّل الأوصاف المقتضبة الواردة في أناجيل يسوع وخدمته. في بعض الحالات، يُدّعى أن هذه الروايات مبنية على مخطوطات مبكرة اكتُشفت مؤخرًا؛ وفي حالات أخرى، على وحي روحي مباشر.

بعض هذه الكتابات معقول للغاية، بينما يُصدّق البعض الآخر.
هناك شائعات مستمرة بأن يسوع زار كلًا من اليونان والهند ودرس فيهما، وأنه تم اكتشاف عملة معدنية سُكّت تكريمًا له في الهند خلال القرن الأول.
من المعروف وجود سجلات مسيحية مبكرة في التبت، ولا يزال رهبان دير بوذي في سيلان يحتفظون بسجل يُشير إلى أن يسوع أقام معهم وأصبح مُلِمًّا بفلسفتهم.
على الرغم من أن المسيحية المبكرة تُظهر كل الدلائل على التأثير الشرقي، إلا أن هذا موضوعٌ تمتنع الكنيسة الحديثة عن مناقشته.
إذا ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن يسوع كان من مُبتدئي الأسرار الوثنية اليونانية أو الآسيوية، فمن المرجح أن يكون تأثير ذلك على الأعضاء الأكثر تحفظاً في الإيمان المسيحي كارثياً.
إذا كان يسوع هو الله المتجسد، كما كشفت المجامع الكنسية المهيبة، فلماذا يُشار إليه في العهد الجديد بأنه “مدعو من الله، رفيع الشأن على رتبة ملكي صادق”؟
إن عبارة “على رتبة” تجعل يسوع واحداً من سلالة أو رتبة لا بد أن يكون هناك آخرون من نفس المكانة أو حتى أعلى منها.
إذا كان “الملكي صادق” هو الحكم الإلهي أو حاكم الكهنة لأمم الأرض قبل تدشين نظام الحكام الدنيويين، فإن الأقوال المنسوبة إلى القديس بولس تُشير إلى أن يسوع إما كان أحد هؤلاء “المختارين الفلاسفة” أو كان يحاول إعادة تأسيس نظام حكمهم.
ويجب أن نتذكر أن ملكي صادق قام أيضًا بنفس مراسم شرب الخمر وكسر الخبز التي قام بها يسوع في العشاء الأخير.
يُعلن جورج فابر أن الاسم الأصلي ليسوع هو جوشو (جوشوا) حماس (هماس) قد اكتشف غودفري هيغينز إشارتين، إحداهما في المدراشجوهليث والأخرى في أبودازارا (التفاسير اليهودية المبكرة للكتاب المقدس)، تفيدان بأن لقب عائلة يوسف كان بانثر ( بانديرا )، إذ ورد في كلا العملين أن رجلاً شُفي “باسم يسوع بن بانثر”.
يُرسي اسم بانثر صلة مباشرة بين يسوع وباخوس الروماني او ديونسيوس اليوناني- الذي أرضعته الفهود، ويُصوَّر أحيانًا راكبًا إما على أحد هذه الحيوانات أو في عربة تجرها.
كما كان جلد النمر مقدسًا في بعض طقوس التنشئة المصرية. ويُمثل الرمز IHS الذي يُفسَّر الآن بمعنى يسوع مخلص البشر (Iesus Hominum Salvator)، و هنا صلة مباشرة أخرى بين الطقوس المسيحية والباخوسية (الديونسيوسية) .
يُشتقّ اسم IHS من الكلمة اليونانية ΥΗΣ، والتي، كما تدلّ قيمتها العددية (608)، تُرمز إلى الشمس وتُشكّل الاسم المقدس والخفيّ لباخوس. (انظر كتاب “الدرويديون الكلتيون” لغودفري هيغينز).
من الجدير بالذكر أيضا أن باخوس الروماني أو ديونسيوس اليوناني هو اله شمسي و ابن كبير الالهة (جوبيتر ، زيوس) و هو أيضا إله شمسي و مخلص و أمه عذراء و هي أميرة طيبة سيميلي و كان (باخوس، ديونسيوس ) معلم متجول و إله تاثر بالثقافات الآسيوية و علي راسها الهندية …
وفقًا للتقاليد الشائعة، جاب ديونيسوس مصر أولًا، حيث استقبله الملك بروتيوس بحفاوة. ثم عبر سوريا، ثم جاب آسيا بأكملها.
وعندما وصل إلى نهر الفرات، بنى جسرًا لعبور النهر، لكن رأي فهد و في بعض الروايات نمر و قد أرسله إليه زيوس و حمله عبر نهر دجلة.
الجزء الأكثر شهرة من تجواله في آسيا هو رحلته إلى الهند، والتي يقال إنها استمرت ثلاث سنوات..
يُطرح السؤال: هل اختلطت المسيحية الرومانية المبكرة بعبادة باخوس بسبب التشبهات العديدة بين الديانتين؟ إذا أمكن إثبات ذلك، فسيتمّ حل العديد من ألغاز العهد الجديد التي كانت غامضة حتى الآن.
ليس من المستبعد أن يكون يسوع نفسه قد اخد هذا الطريق في البداية اي نفس طريق باخوس ديونسيوس، على سبيل المجاز، الأنشطة الكونية التي اختلطت لاحقًا بحياته.
ولا جدال في أن كريستوس، أي خريستوس، يمثل القوة الشمسية التي تجلّها كل أمة في العصور القديمة.
فإذا كان يسوع قد كشف عن طبيعة هذه القوة الشمسية وغايتها باسم خريستوس وشخصيته، مانحًا إياها صفات الإله-الإنسان، فإنه اتبع سابقة وضعها جميع معلمي العالم السابقين.
هذا الإله-الإنسان، الموصوف بجميع صفات الألوهية، يدل على الألوهية الكامنة في كل إنسان. لا يبلغ الإنسان الفاني التأله إلا من خلال الاتحاد بهذه الذات الإلهية.
الاتحاد مع الذات الخالدة يُشكّل الخلود، ومن يجد ذاته الحقيقية يكون قد “خلص”.
هذا الخريستوس (المسيح)، أو الإنسان الإلهي في الإنسان، هو أمل الإنسان الحقيقي في الخلاص الوسيط الحي بين الألوهية المجردة والبشرية الفانية.
كما كان أتيس وأدونيس وباخوس و ديونسيوس وأورفيوس، على الأرجح، رجالاً مستنيرين في الأصل، ثم خُيِّطَ بهم فيما بعد مع الشخصيات الرمزية التي خلقوها تجسيداً لهذه القدرة الإلهية، فكذلك خُيِّبَ يسوع مع المسيح، أو الإنسان الإلهي، الذي بشَّر بعجائبه.
ولأن المسيح كان الإنسان الإلهي المسجون في كل مخلوق، كان من أولى واجبات المبتدئ تحرير هذا الأزلي في داخله، أو “إحيائه”.
ومن نال الاتحاد مع المسيح، أُطلق عليه بالتالي اسم مسيحي، أو إنسان مُعمَّد.
من أعمق عقائد الفلاسفة الوثنيين مسألة الإله المخلص الكوني الذي رفع أرواح البشر المتجددين إلى السماء بطبيعته.
وقد استوحى هذا المفهوم، بلا شك، الكلمات المنسوبة إلى يسوع: “أنا هو الطريق والحق والحياة. لا يأتي أحد إلى الآب إلا بي”.
وفي محاولةٍ لجعل يسوع ومسيحه شخصًا واحدًا، رصّ الكُتّاب المسيحيون عقيدةً يجب إعادة تحليلها إلى مكوناتها الأصلية إذا أُريد إعادة اكتشاف المعنى الحقيقي للمسيحية.
في روايات الأناجيل، يُمثل المسيح الإنسان الكامل الذي، بعد أن اجتاز مراحل “سر العالم” المختلفة، التي تُرمز إليها السنوات الثلاث والثلاثون، يصعد إلى السماء حيث يلتقي بأبيه الأزلي.
إن قصة يسوع كما هي محفوظة الآن – مثل قصة حيرام أبيف الماسونية – جزءٌ من طقوسٍ تبشيرية سرية تنتمي إلى الأسرار المسيحية والوثنية المبكرة.
خلال القرون التي سبقت العصر المسيحي، سقطت أسرار الوثنية تدريجيًا في أيدي غير المتدينين. ويتضح لدارسي الأديان المقارنة أن هذه الأسرار، التي جمعتها مجموعة صغيرة من الفلاسفة والمتصوفين المؤمنين، أُعيد إلباسها ثوبًا رمزيًا جديدًا، وبالتالي حُفظت لعدة قرون تحت اسم المسيحية الصوفية.
ويُفترض عمومًا أن الأسينيين كانوا أمناء هذه المعرفة، وكانوا أيضًا مُنشئي ومُعلمي يسوع.
وإذا كان الأمر كذلك، فلا شك أن يسوع قد تلقّى تعليمه في معبد ملكي صادق نفسه الذي درس فيه فيثاغورس قبل ستة قرون.
كان الأسينيون – أبرز الطوائف السورية القديمة – طائفة من الرجال والنساء الأتقياء الذين عاشوا حياة زهد، يقضون أيامهم في أعمال بسيطة وأمسياتهم في الصلاة.
وقد أشاد بهم المؤرخ اليهودي الكبير يوسيفوس أشد الإشادة، قائلاً:
“إنهم يُعلّمون خلود الروح، ويُقدّرون أن ثواب البرّ يجب السعي إليه بجدّ”.
ويضيف في موضع آخر: “ومع ذلك، فإنّ أسلوب حياتهم أفضل من أسلوب حياة غيرهم، وهم مُنغمسون كلياً في الزراعة”.
ويُفترض أن اسم الأسينيين مُشتق من كلمة سورية قديمة تعني “طبيب”،
ويُعتقد أن هؤلاء الناس الطيبين قد جعلوا من غرض وجودهم شفاء المرضى في عقولهم وأرواحهم وأجسادهم.
ووفقاً لإدوارد شوري، كان لديهم جماعتان رئيسيتان، أو مركزان، إحداهما في مصر على ضفاف بحيرة مورس موريس و هي تعرف حاليا باسم بحيرة قارون ، والأخرى في فلسطين في عين جادّي (عين جدي) ، بالقرب من البحر الميت.
يُرجع بعض المرجعيات أصول الأسينيين إلى مدارس النبي صموئيل، لكن معظمهم يُجمع على أصل مصري أو شرقي.
لم تختلف أساليبهم في الصلاة والتأمل والصيام عن أساليب رجال الدين في الشرق الأقصى.
لم يكن الانضمام إلى الرهبنة الأسينية ممكنًا إلا بعد عام من الاختبار.
كانت هذه المدرسة السرية، كغيرها من المدارس، تضم ثلاث درجات، ولم ينجح في جميعها سوى عدد قليل من المرشحين.
انقسم الأسينيون إلى جماعتين متميزتين، إحداهما تضم العزاب والأخرى تضم أعضاءً متزوجين.
لم يصبح الأسينيون تجارًا قط أو دخلوا الحياة التجارية في المدن، لكنهم حافظوا على أنفسهم من خلال الزراعة وتربية الأغنام للحصول على الصوف؛ وكذلك من خلال حرف مثل الفخار والنجارة.
في الأناجيل والأبوكريفا، يشار إلى يوسف، والد يسوع، على أنه نجار وخزاف في نفس الوقت.
في إنجيل توما الأبوكريفي وأيضًا في إنجيل متى المنحول، وُصف الطفل يسوع بأنه يصنع عصافير من الطين التي عادت إلى الحياة وطارت بعيدًا عندما صفق بيديه.
كان الأسينيون يُعتبرون من بين الطبقة الأفضل تعليماً من اليهود، وهناك روايات عن اختيارهم كمعلمين لأطفال الضباط الرومان المتمركزين في سوريا.إن حقيقة إدراج هذا العدد الكبير من الحرفيين بين عددهم هي المسؤولة عن اعتبار النظام سلفًا للماسونية الحديثة. تتضمن رموز الأسينيين عددًا من أدوات البناء، وكانوا منخرطين سرًا في تشييد معبد روحي وفلسفي ليكون بمثابة مسكن للإله الحي.
مثل الغنوصيين، كان الأسينيون من أتباع مذهب الفيض.
وكان من أهم أهدافهم إعادة تفسير الشريعة الموسوية وفقًا لمفاتيح روحية سرية معينة احتفظوا بها منذ تأسيس طائفتهم.
ويترتب على ذلك أن الأسينيين كانوا قباليين، ومثل العديد من الطوائف المعاصرة الأخرى المزدهرة في سوريا، كانوا ينتظرون مجيء المسيح الموعود به في الكتابات التوراتية المبكرة.
ويُعتقد أن يوسف ومريم، والدي يسوع، كانا عضوين في طائفة الأسينيين.
وكان يوسف أكبر من مريم بسنوات عديدة. ووفقًا لإنجيل “بروتفانجيليوم”، كان أرملًا وله أبناء كبار، وفي إنجيل متى المنسوب إليه، يشير إلى مريم بأنها طفلة صغيرة أصغر سنًا من أحفاده.
وفي طفولتها، كُرِّست مريم للرب، وتحتوي كتابات الأبوكريفا على العديد من الروايات عن معجزات مرتبطة بطفولتها المبكرة. عندما بلغت الثانية عشرة من عمرها، تشاور الكهنة بشأن مستقبل هذه الطفلة التي نذرت نفسها للرب.
فدخل رئيس الكهنة اليهودي، حاملاً الدرع، قدس الأقداس، فظهر له ملاك قائلاً: “يا زكريا، اخرج وادع أرمل الشعب، وليأخذ كل واحد منهم عصا، فتكون زوجة لمن يُظهر له الرب آية”.
خرج يوسف للقاء الكهنة على رأس الأرامل، وجمع عصي جميع الرجال الآخرين وسلمها للكهنة.
كانت عصا يوسف نصف طول العصي الأخرى، فلما أعاد الكهنة العصي إلى الأرامل، لم يُعرها الكهنة اهتماماً، بل تركوها في قدس الأقداس. وعندما استعاد الأرامل عصيهم، انتظر الكهنة آية من السماء، لكن لم تأتِ.
ونظرًا لتقدمه في السن، لم يطلب يوسف إعادة عصاه، إذ كان من غير المعقول أن يُختار.
لكن ظهر ملاك لرئيس الكهنة، وأمره بإعادة العصا القصيرة التي كانت في قدس الأقداس خفيةً.
وبينما كان رئيس الكهنة يُسلم العصا ليوسف، طارت حمامة بيضاء من طرفها واستقرت على رأس النجار العجوز، فأُعطي له الطفلة.
يُلفت مُحرِّر “الكتب المُقدَّسة وأدب الشرق القديم” الانتباه إلى الروح الغريبة التي تُعالج بها مُعظم أسفار العهد الجديد المنحولة قصة طفولة يسوع، وخاصةً في أحد الأعمال المُنسوبة إلى توما المُتشكِّك، والذي يعود تاريخ أقدم نسخة يونانية معروفة منه إلى حوالي عام 200 ميلادي:
“يُصوَّر الطفل المسيح كعفريت تقريبًا، يلعن ويُدمِّر من يُزعجه”.
كان هذا العمل المنحول، المُصمَّم لإثارة الخوف والرعدة في قلوب قرَّائه، شائعًا في العصور الوسطى لتوافقه التام مع روح المسيحية القاسية والمُضطهِدة في تلك الحقبة.
ومثل العديد من الكتب المُقدَّسة القديمة الأخرى، فُنِّدَ كتاب توما لغرضين مُترابطين: أولًا، التفوق على الوثنيين في صنع المعجزات؛ وثانيًا، إلهام جميع غير المؤمنين بـ”مخافة الرب”.
لا تستند هذه الكتابات المنحولة إلى أي أساس واقعي. كانت “معجزات” المسيحية، التي كانت في وقتٍ ما ميزةً ثمينة، أكبر عبئٍ عليها.
إن الظواهر الخارقة للطبيعة، التي تم تحريفها في عصر ساذج لإقناع الجهلاء، لم تحقق في هذا القرن سوى عزلة الأذكياء.

في إنجيل نيقوديموس اليوناني، ورد أنه عندما أُحضر يسوع إلى بيلاطس، انحنت رايات الحرس الروماني إجلالاً له، رغم كل الجهود التي بذلها الجنود لمنع ذلك. وفي رسائل بيلاطس، ورد أيضاً أن قيصر، غضب على بيلاطس لإعدامه رجلاً باراً، فأمر بقطع رأسه. وصلى بيلاطس طالباً المغفرة، فزاره ملاك الرب، وطمأن الحاكم الروماني، ووعده بأن يتذكر العالم المسيحي بأكمله اسمه، وأنه عندما يأتي المسيح ثانية ليدين شعبه، يجب أن يأتي (بيلاطس) أمامه شاهداً له.
تُمثل قصصٌ كهذه الترسُّبات التي لصقت بجسد المسيحية على مر العصور.
وقد نصَّب العقل الشعبي نفسه حارسًا لهذه الأساطير ومُخلِّدًا لها، مُعارضًا بشدة كلَّ جهدٍ لنزع هذه التراكمات المشكوك فيها عن الإيمان.
وبينما تحتوي التقاليد الشعبية غالبًا على بعض عناصر الحقيقة الأساسية، فإنَّ هذه العناصر عادةً ما تُحرَّف بشكلٍ مُفرط. وهكذا، فبينما قد تكون عموميات القصة صحيحةً في جوهرها، فإنَّ تفاصيلها خاطئةٌ بشكلٍ مُيؤوسٍ منه.
يُمكن القول إنَّ الحقيقة، كما الجمال، تُزيَّن أكثر ما تُزيَّن به عندما لا تُزيَّن.
ومن خلال ضباب الروايات الخيالية التي تُطمس الأساس الحقيقي للإيمان المسيحي، لا تتضح إلا بشكلٍ خافتٍ للقلة المُتبصرة عقيدةٌ عظيمةٌ ونبيلةٌ نُقِلَت إلى العالم من قِبَل روحٍ عظيمةٍ ونبيلة. يوسف ومريم، روحان متدينتان طاهرتان، كُرِّستا لخدمة الله، وكانا يحلمان بمجيء المسيح لخدمة بنى إسرائيل، أطاعا أوامر رئيس كهنة الأسينيين بإعداد جسد لمجيء نفس عظيمة.
وهكذا وُلد يسوع من حبلٍ بلا دنس.
ويُقصد بالطهارة الطهارة، لا ما وراء الطبيعة.
نشأ يسوع وتعلم على يد الأسينيين، ثم دُرِّس في أعمق أسرارهم.
وكسائر المبتدئين العظام، كان عليه أن يسافر شرقًا، ولا شك أن سنوات حياته الصامتة قد قضاها في التعرّف على ذلك التعليم السري الذي سينقله لاحقًا إلى العالم.
وبعد أن أتمَّ ممارسات الزهد في رهبنته، بلغ المعمودية.
وبعد أن عاد إلى مصدره الروحي، انطلق باسم من صُلب منذ ما قبل العوالم، وجمع حوله تلاميذه ورسله، وعلّمهم ذلك التعليم السري الذي فُقد – جزئيًا على الأقل – من عقائد إسرائيل.
مصيره مجهول، ولكن من المرجح أنه عانى من الاضطهاد الذي يُصيب من يسعون إلى إعادة بناء الأنظمة الأخلاقية أو الفلسفية أو الدينية في عصرهم.
خاطب يسوع الجموع بالأمثال، وخاطب تلاميذه أيضًا بالأمثال، وإن كان ذلك في سياق أسمى وأكثر فلسفية.
قال فولتير إنه كان ينبغي للكنيسة المسيحية أن تُقدّس أفلاطون، لأنه، كونه أول من روّج لسر المسيح، ساهم في مبادئه الأساسية أكثر من أي فرد آخر.
كشف يسوع لتلاميذه أن العالم السفلي تحت سيطرة كائن روحي عظيم شكّله وفقًا لإرادة الآب الأزلي.
كان عقل هذا الملاك العظيم عقل العالم وعقله الدنيوي في آن واحد.
ولكي لا يموت البشر من دنيويتهم، أرسل الآب الأزلي إلى الخليقة أقدم وأسمى قدراته – العقل الإلهي.
قدّم هذا العقل الإلهي نفسه ذبيحة حية، فكسره العالم وأكله.
وبعد أن أعطى روحه وجسده في عشاء سري مقدس للمخلوقات العاقلة الاثنتي عشرة، أصبح هذا العقل الإلهي جزءًا من كل كائن حي.
وهكذا، أصبح الإنسان قادرًا على استخدام هذه القوة كجسرٍ يعبره وينال الخلود.
من رفع روحه إلى هذا العقل الإلهي وخدمه كان بارًا، وبعد أن بلغ البر، حرر هذا العقل الإلهي، الذي عاد مجدًا إلى مصدره الإلهي.
ولأنه أوصلهم إلى هذه المعرفة، قال التلاميذ لبعضهم البعض: “هوذا هو هذا العقل متجسدًا!” – مانلي ب. هول، التعاليم السرية لكل العصور.

